...
ساعة أخرى انتظرناها على الرصيف نرقب عشرات المركبات التى بدأت تتدفق على المدينة الساحلية الصغيرة ، أخذ يحكى لى كيف أن صغيرته ستطير فرحا بمدينتنا هذه ، فهى لم تر قبل ذلك أى مدن ، هى لم تخرج من سجنها الكبير منذ أتت إلى الدنيا ، قد حفظت كل الأماكن التى يمكن أن ترتادها وهى لم تتجاوز ست أعوام بعد ، يترقرق الدمع فى عينيه وهو يخبرنى كم كان يتمنى أن يأتى هذا اليوم الذى يستطيع أن يخرج بها وأمها وأخواتها فى طرقات لم يطئوها ، ومتنزهات لم يشموا روائح عطرها قبلا ، وشواطىء لم يتحسسوا ناعم رمالها بعد ، أغفيت قليلا وهو يحدثنى فقد كنت جد متعبا ، أشفق على وسمح لى بأن أسبقه للبيت وينتظر هو حتى يأتون .
ساعات من الليل وانفتحت عيناى على أشعة النهار وأصوات الريح تتلاعب بأمواج البحر وأوراق النخيل ، وإذا بصوتها يدوى فى أرجاء البيت ، يا الله لقد جاءت ، خرجت من غرفتى لأجدها أمامى غير منتبهة لى ، ترتدى معطفا ثقيلا يكاد يصل لأطراف أصابعها الصغيرة ، وتمسك بكيس من الحلوى التى ظهرت آثارها على فمها ولونت بها وجنتيها البدريتين ، لمحتنى بعيناها السوداوين فاخفت ابتسامة خجولة خلف أسنانها الصغيرة البيضاء وانزوت جانبا تلوذ بأخيها الصغير وتحنى رأسها للأرض ، لمست أناملى ذقنها رافعة وجهها الحيى إلى عينى : إذن أنت مُنى ، أجابت بتلقائية تريد أن تفلت بها منى : وهاد خوى إبراهيم ، وإختى ولاء الصغيرة هونيك (تشير إلى الغرفة المغلقة فى آخر الردهة) مع إمى ، وأخذت تجرى نحو الغرفة وتنادى : إمى إمى إمى .
ساعات من النهار وكنا نقف ثانية أمام البيت ،نحزم الحقائب ونتأكد من أن كل شىء على ما يرام ، يشكرنى على شىء حقه أن يوبخنى عليه ، ينظر لعيناى المنكسرتين فيربت على كتفى مخففا عنى :
- على الأقل اختلسنا ساعة من نهار .
- يمكنكم أن تبيتوا الليلة وتنطلقوا من الغد .
- لا يا أحمد قد طوقوا السوق ، وحمدت الله أن منى لم تراهم يفعلون ذلك ، كانت ستفلت ذراعى وترميهم بالحجر ، لم أخبرها بعد أن هناك يهودا خارج بلادنا ، وعلى كل حال لقد استمتعت اليوم ، شربت عصير القصب واشترت حليا لها ، أيضا زوجتى لم تشترى لها ولا للبيت شيئا منذ ثمانية أشهر ، ولا ندرى إن بقينا لليل فقد نفقد كل ما جمعناه فى الصباح .
نزلت وهى تنادى بأعلى صوتها وتجرى على : عمو أحمد عمو أحمد ، ما راح تاجى معنا .
لأجل خاطرك سآتى ، ولكن سأبيت عندكم ليلة واحدة فقط ، وبعدها تتركينى اتفقنا ، أخذت تهلل وتجرى حولى معلنة للجميع أنى سآتى معهم .
انتصب الطريق بنا فى طول غير معهود ، شعرت برأسى ثقيلة ترتطم بزجاج السيارة كل حين ، هؤلاء العشرات العائدين على جانبى الطريق قابلتهم بغير هذا الوجه فى الصباح ،أتذكر فرحة منى بالعريش ، بأسواقها التى لا تختلف عن أسواق غزة كثيرا فى الشكل لكنها ممتلأة وزاخرة ، بحدائقها الصغيرة التى لا تختلف عما رأته إلا بقدر المساحات السوداء التى تغطى بعض شجيراتها هناك ، شواطئها لا يفصل امتدادهما إلا تلك الزوارق المرابطة فى المياه من بعيد تعلن أن هنا بداية الشاطىء الغزاوى ، بعد ساعة توقفت السيارة على بعد بضعة مئات من الأمتار من مدينتهم ، نزل السائق يسئل عن سر توقف الطريق ، مئات من المركبات تغص بهم الطرقات من حولنا وكلهم ركود ، عاد السائق بعد هنيهة ، اتكأ بذراعيه على باب السيارة ، وأدخل رأسه عبر النافذة النصف مفتوحة موجها الحديث إلينا : لقد أغلق المعبر من ساعة ، إما أن تبيتون هنا للصباح وإما أن تسيرون من هنا – مشيرا إلى طريق ترابى يسلكه راجلون - على الأقدام إلى أن تصلوا .
نزلنا مضطرين ، أن تحاصر فى بيتك خير من أن تحصر فى بيت جارك ، هكذا قالوا ، وهكذا دفعنا للرجل مئة من الجنيهات فى مشوار لم يكن يحلم بأن يحصّل منه سوى عشرة جنيهات ، كما لم يكن يحلم أى سيناوى بأن يغتنى فى هذه الفترة القصيرة ، وأن يبيع بأضعاف أثمان ما كان يبعيه ، وأن يكون حصار أناس فى أرض كتب الله أن تجاورهم ، هو رخاؤهم وغناهم فى غفلة من الزمن ، بل فى وهدة من الأيام تكاد تذهب بالدماء التى نزفت على هذه الأرض المطهرة عبر الأزمان ، تركت أفكارى المصرية ترحل مع السائق و بدأنا فى المسير ، ها قد أذنت الشمس على المغيب ، وها قد بدأت أشعة غروبها تبث ألوانا من البؤس والحسرة على عشرات بل مئات من الوجوه السائرة من حولنا نحو مصير محتوم ، تلون وجوه الأطفل والنساء والكهول بألوان عشرات من شجيرات الزيتون التى نخترق أراضيها وصولا للسور ، كالمسروق منهم فرحة بالعيد ، فى مشهد طالما بكيت أمامه فى "التغريبة الفلسطينية" وفى "باب الشمس" ، فى مشهد لا يظهر منه إلا الأبيض والأسود فى عشرات من شرائط توثيق النكبة أراه هنا كامل الألوان ، يبعث فى النفس ما يبعث ، يحملنى على أن أعتصر يد منى من فرط الحرص وأنظر إليها كل فينة : منى تعبت أحملك قليلا ، لا أنا كبيرة مو متل إبراهيم وولاء ، أنظر إلى أبيها يحمل الطفل وإلى أمها تحمل حملين حمل فى رحمها عمره ثلاثة شهور وحمل على ذراعيها عمرها زهاء سنتين ، أهز رأسى موافقا وأكمل المسير ، ومع تصاعد الغبار- من المسير- الذى بدأ يتحالف مع خيوط الليل السوداء فى سد الآفاق من حولنا وجدنا أنفسنا أمام السور وعشرات من السلالم المنصوبة على جانبيه ليتمكن الناس من العبور بعد أن أغلقت المنافذ التى فتحت عبر اليومين الماضيين ، وما إن اقتربنا أكثر حتى وجدت هذه الأصوات المألوفة لدى تنادى : يالا السلم ب5 جنيه ، وابتلعت حسرة طويلة ، وانطوت نفسى على جمرات كدت أقذفها فى وجوههم المنفرة وأبواقهم المنكرة ، فلا يفصل بين السور – المهدم أصلا – والأرض إلا أقل من مترين ولولا صغيرتى لكنت صفعتهم ومررت .
......
"تكبير .. الله أكبر .. تكبير .. الله أكبر " " منصورة ما منصورة يا حماس منصورة " " أبا العبد .. احنا معاك .. أبا العبد " .. فتحت عيناى بصعوبة على هذه الأصوات ورحت أتلفت حولى ، فلم أجدها ، الأصوات تأتى من النافذة ، تتضح شيئا فشيئا إنها ليست إلا أصوات لأطفال ، لكنها تشبه مظاهرة صغيرة ، رحت على النافذة أفتحها سريعا فإذا بالضوء يعشى ناظرى قبل أن أتقيه بذراعى وأنظر بروية إلى حديقة المنزل لأجدهم يتوسطونها بأرجوحتهم المتواضعة ، وكقائد لكتيبة بذراعها تطيح منى بالأطفال على الأرجوحة ، وتزعق بصوتها : تكبير .. فيردون بصوت يهز المكان : الله أكبر ، أخذتُ أنفاسى بعدما اطمأننت أن الحرب لم تقم بعد ، وقبل أن أبتعد مرة أخرى عن النافذة لمحتنى فتركت الأطفال وجرت نحو سلم المنزل تنادى : عمو أحمد صحى .
دقائق ووجدتها تدخل على بصينية كبيرة ويحاول أبوها عبثا أن يساعدها وهى تأبى وتسرع بها حتى كادت أن تسقط الأطباق كلها على لولا أننى تداركتها متبسما : شطور يا منونة انت ياللى جهزتى الفطور لحالك .
- آه ، بس البطاطس لأ .
- أخذت تضحك هى وأبوها وأنا لا أعرف مغزى الطرفة .
أخذت تبدى دهشات مصطنعة وتقول : عمو أحمد انت تحب الطاطس ؟
- فأومىء بالإجياب وقبل أن أبدأ فى تلقينها درسا تربويا عن حب كل المأكولات لأنها رزق من الله ، تأخذ هى فى الضحك وتقول : عنجد تحب البطاطس الصفرا ، يعنى انت فتحاوى ، بابا عمو أحمد فتحاوى ، متل دحلان وأبو سميح
- أخذتنى ضحكة شديدة من فرط المفاجئة ، لكننى اصطنعت بعدها الجهل : ليش منى الفتجاوى مو منيح ؟
- زمجرت الفتاة وقطبت عن جبينها بشدة : لا مو منيح ، كيف يعنى منيح وهو ما بيحارب اليهود ، وبيطخ فى حماس ، ثم انقضت بيدها على حفنة من تلك الصوابع الصفراء ودستها فى فيها الصغير وهى تضحك .
أخذنى الإعجاب بذلك المجتمع الذى يصل أطفاله إلى هذه الدرجة من الوعى السياسى فى معركته الداخلية فضلا عن الخارجية منها ولكن رأسى لم تكن فى سعة من التفكير والتحليل الكثير وقتها ، فمنى تنظر إلى رد فعلى الواجم هذا ولا تفهم ما الخطأ فى حديثها ، حاولت أن أدير الموضوع : منى انت ما حكيتى لى إنك راح تعرفينى على عمو ، فهرعت إلى درج المكتب فى الغرفة وأخرجت صورة كبيرة احتضنتها بقوة وأتت بها إلى :
- شوف هذا عمى الشهيد إبراهيم ، أنا بحبو كتير ، ولما نستشهد متله راح نروح كلنا الجنة ونعيش من بعض ، مو هيك بابا
- توقفت الكلمات فى حلقى ولكنها أكملت
- شايف هاد الكلاشين تبعه ( وأخذت تهز رأسها وتقول بلهجة عجب ) عمو أحمد أنا بعرف أسلخ نار ، رحت مع بابا عالجبل وسلخت نار ، انت تعرف تسلخ نار عمو أحمد .
- غاصت الكلمات فى جوفى ، وتذكرت فورا ذلك الصوت الذى هز أركان المعسكر منذ وقت مضى "دفعة 87 تأجيـــــل" ومشهد مئات الشباب وهم يسجدون على الأرض فور سماعهم الخبر ، مشهد تلك الدولة التى أفلحت فى أن تنفر أجيالا بأكملها من السلاح فرارها من الأسد !
أشفق علىَّ أبوها وجذبها من بين ذراعى : منى ما راح تفرجى عمو على أساورك .
- فمدت إليها ذراعها الأيمن الممتلىء بحلقات بلاستيكية ذهبية وملونة وقالت فى دلال : ماما جابتها إلى من العريش ، حلوة عمو؟
- أمسكت بأناملها الممتدة وطبعت قبلة حانية على يدها الرقيقة مداعبا : انت أحلى يا منونة .

الشمس ساطعة والسماء تمطر بغزارة ، مشهد ودعتنى به سماء تلك المدينة المطهرة ، لا أدرى كيف شعرت ساعة الوداع أننى ما كنت هناك إلا بخلدى ، ما سافر معى جسدى كل هذه المسافات ، تركته هناك بأرضه ، أستلمته الآن على الحدود ، ألقيت به فى أول سيارة مسرعة ودعته من بعيد بقلب تركته عند مالكيه ، أخذت أغفو وتميل رأسى على زجاج السيارة المضبب ، أخذت أتخفف منه فى أحلام بعيدة ، أصوات الأطفال ، مذاق الزيتون ، زمجرة النيران ، دفىء البيوت ، ضربات مساند "القعدة العربى" التى تنهال فوق رأسى منها ومن أخيها، لوحات يتداخل فيها جسدى بجسديهما ، ألوان تتمازج فيها نبراتى بضحكاتها ، أمواج من البحر تتلاعب بخصيلات من شعرها ، ذرات من الرمل تتراسم بخطوط من أناملها ، أخذت أحلم بكل هذا طويلا طويلا ، ليالى وأياما ، لا أود عندما يراودنى أن أفيق ، ما بال موقظنى اليوم يصرخ فى أن أفق أفق ، فتحت عيناى قليلا ، ألقى على الخبر ، انقلبت من على الفراش وطاح جسدى فى الغرفة حتى استويت إلى جهازى وأخذت أقلب فى الشبكة وأكتب بحروف مرتجفة على محرك البحث فى الأخبار "نزار ريان" وما أن ظهرت النتائج حتى اختفى كل شىء من أمامى ، صحت صيحة عويل مدوية ، سقطت على ظهرى ، توقفت أنفاسى للحظة ، انعدلت إلى التلفاز ، وما أن رأيت الحلم محطما أشلاء حتى على صياحى وفر الدمع فى كل عروقى كالمذبوح ، حفرة عميقة حيث كان البيت العامر ، نيران ملتهبة حيث كانت الحديقة الغناء ، استشهد الشيخ ومعظم عائلته ، شهقت شهقة تنميت أن تذهب بروحى ، سقطت مرتجفا كالمشلول ، أجأر ببكاء لم تشهدة عينى من قبل ، فى محاولة يائسة ككل يوم – منذ بداية الحرب – أتصل بوالدها ، فى لقطة فريدة من الزمن أسمع صوته من بين الدمار ، مختنق بالدمع ، ملتفع بالصمود : أبى يا أحمد واتناش من عيلتى ذهبوا ، أمى يا أحمد ، إخوتى يا أحمد ، أخواتى يا أحمد ، أولادهم يا أحمد ، بناتهم ، خالاتى يا أحمد ، وما أحمد كى ينطق فى مثل هذا الموقف إلا ذهولا يردد بضعف : صبرا آل نزار إن موعدكم الجنة .. صبرا آل نزار إن موعدكم الجنة .
غابت البسمة عن عينى منى فى أحلام ما بعد الحرب ، وما الأحلام إلا سذاجات بنى آدم التى لا يسطيعها إلا بإغلاق أجفانه ، نعم لن أقوى على فتحها أمام عينها وقد ازدادت صمودا على ما كانت ، كيف ستكون إذن ، كيف بها تعرفنى إلى أهلها جميعا فى الصور ، ترصصها إلى جوار عمها إبراهيم ، جدها نزار ، زوجاته ، أعمامها ، عماتها ، لكنها تسرع إلى الغرفة المجاورة – كمن نسيت شخصا تريد أن أتعرف عليه – وتحمل بقوة على ذراعيها أخيها الذى مر على مدينتنا وهو فى رحم أمه ، تحمل نزار الصغير ، تحمل النبتة التى خرجت وتخرج بكل قطرة دم على هذه الأرض المطهرة ، أراها تقترب به منى ، إنها تكاد تلمس ذراعى ، لا إنها تغوض بأناملها فيه بقوة ، أكاد أشعر بطاقة تعترى جسدى كله ، أغمض عيناى أكثر ، تهز فى ذراعى أكثر وبقوة ، تنادى بصوت خفيض أنظر إلى ، افتح عينيك ، أبى أبى أبى : أستيقظ مذهولا من الكلمة ، تنظر عيناى فى سقف الغرفة المظلمة ، أتطلع إلى مصدر الصوت بجوارى ، أنزعج متسائلا : أروى .. ماذا بك يا صغيرتى !
تجيب الصغيرة التى بدأت تفرك فى عينيها اللامعتين برغم خفوت الأضواء : أريد أن أنام بجواركما .
أطبق بإصبعى على فيها : لا تسمعك أمك .
تنظر إلى بنظرة عتاب أضعف أمامها ، أسحب ذراعى من تحت الحالمة بجوارى كى ألتقف به صغيرتى مبتسما فى خبث تندرى ، وهى تكتم الضحكات بكل ما استطاعت ، حتى إذا استقرت بيننا همست : أما الآن فالحكاية أولا .
أحك رأسى مصطنعا التفكير : طيب الحكاية أولا .. كان فيه بنت اسمها .. اسمها .. اسمها !
تتسع عيناها كمن عرفت الإجابة وتلهفت إلى سماع القصة التى أرددها كثيرا ولا تمل منها وتقول بصوت واحد تتبعها ضحكات عالية : اسمها منى .













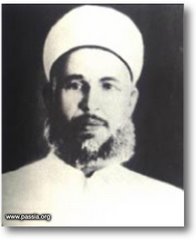



































































































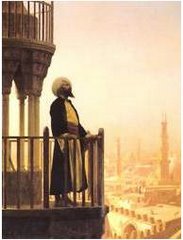






هناك تعليقان (2):
رائعة :)
أحب الذاكرة القوية في الكتابة وأحب الصدق في المشاعر الذي ظهر في كل كلمة كتبتها .. لو لم يكن كلامك من القلب لما وصل لقلبي بهذه السهولة .. صفاء لحظاتك مع عائلة الأخ بلال ترسل للقلب حنينا للوقوف في لحظة واحدة فقط منهن.
إرسال تعليق