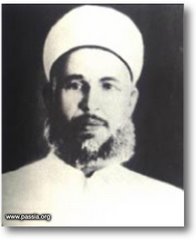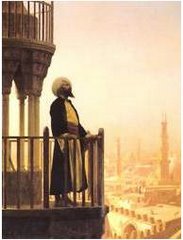مشتقاتُ هذه الأحرفِ تمتد لتشمل قيما كثيرة فى الحياة ، فمن أول اسم الله "المؤمن"، إلى الصفة التى يعتقد بها الناس فى أديانهم "الإيمان" ، إلى الهدف الأسمى الذى خلق الله البشرية من أجله "حمل الأمانة" ، إلى الوصف الذى أثبته الله على النعيم الأخروى " ما جمع الله لعبد من أمنين ولا خوفين .. ".
إذن فالأمن هو شعور معنوى له عناصر داخلية أغلبها مستقاة من مصادر غيبية أو ميتافيزيقية من فكرة الإيمان بالقدر، والإيمان بأن هناك حياة أخرى ، والإيمان بأن أى أذى جزئى (بدنى أو معنوى) للذات البشرية سيُعوض عنه الإنسانُ بشكل ما فى حياة أخرى ( حتى الشوكة يشاكها) ، وأن أى أذى كلى (الموت) سينقلها مباشرة إلى عالم آخر يتم التمتع فيه بالأمن الكامل (أولائك لهم الأمن وهم مهتدون) لأن فكرة الخلود نفسها هى "أمن" ضد الموت، ولذا فإن مشكلة غير المؤمنين دائما هو انعدام الأمن الداخلى الذى قد يؤدى بهم إلى الإسراف فى أحد الجانبين ، الحرص التام على عدم تعريض الذات البشرية للخطر (التأمين على الحياة مثلا ) ، أو التفريط التام فى تعريض ذاتهم للخطر (الانتحار مثلا ).
أما عناصر الأمن الخارجية فهى تتمثل فى أشياء مادية ، إذا لم تتوفر يصاب الإنسان بنسب من الخوف حتى لو كان لديه رصيدٌ كاف من عناصر الأمن الداخلى ، وهو بلاء كأى بلاء مادى يصيب الإنسان ( الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ) ، بل وينال من أعلى البشر الذين يتمتعون بالأمن الداخلى (وإذ زاغت الأبصار وبغلت القلوب الحناجر) ، وسماه الله خوفا بالمعنى الصريح مرتين فى سورة الأحزاب ( جاء الخوف / ذهب الخوف).
والعلاقة بين الأمنين الداخلى والخارجى أراها فى الغالب عكسية فى الحياة فإذا قل الأمن الخارجى زاد الأمن الداخلى ، لأن الركون إلى أسباب الأمن الظاهرة أو الدنيوية إذا انقطعت يلجأ الإنسان إلى توثيق صلاته بأسباب الأمن الداخلى اليقينى والغيبى ، وإذا زادت أسباب الأمن الخارجى فإن الإنسان يركن إليها قليلا على حساب اللواذ بأسباب الأمن الداخلى، هذا على مستوى الفرد ، فما الحاصل على مستوى الجماعة.
على مستوى الجماعة دائما ما تنسج لحظات انعدام الأمن الخارجى خيوط الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أسوء أو أفضل حالا على حسب درجات الأمن الداخلى الذى تتمتع به هذه الجماعة ، فأوقات الحروب أو الفتوح أو الثورات الداخلية دائما ما تنعدم فيها أسباب الأمن الخارجية لدى الجماعة ، لكن فى الوقت نفسه يقاس مدى نجاح النتائج المرتقبة من هذه المرحلة بعمق الأمن الداخلى الجمعى وقوة توجيهه فى الهدف الذى من أجله تجتمع هذه الجماعة عليه.
أما فيما بعد مراحل الاستقرار فإن منحيات الصعود والإبداع دائما ما ترتهن بمستويات عالية من الأمن الخارجى والداخلى على السواء (على مستوى الجماعة كما ذكرت ) ، فإذا كانت يد البنا لا تحكم رص اللبنات وهى مرتعشة ، فمن باب أولى يد الرسام لا تستطيع المسك بالفرشاة من الأساس إذا كانت أيضا مرتعشة .
لكن الأفراد غير التقليديين من القادة والعلماء والمبدعين دائما ما يتعاملون مع مساحة من الخوف الخارجى لأنه فى الغالب ما يقومون بإنتاجه يثير ردود الأفعال التى تكون تارة فى صالح هذا الإنتاج وتارة ضده ، فلو كان شيئا عاديا لا يغير من واقع الناس لما لفت انتباه أحد من الأساس.
لذا فالقاعدة الأساسية فى حياة الفرد أو الجماعة الطامحة المؤثرة أن تكون مستهدفا لألوان من الخوف يعزز من استفزازية تحركهم نحو ما يصبون إليه ، وفرض رؤيتهم فى الواقع كى يأمَنُ إليها من يلونهم من البشر البسطاء العاديين المؤيدين أو حتى التابعين.
تاريخيا نجدُ أن الجماعة المؤمنة كانت فى محل خوف خارجى شبه دائم ، يلخص حالتها مثلا إبان فترة تأسيس الدولة الإسلامية ( من أول الهجرة إلى فتح مكة ) وصفُ أحدِ الصحابة حالـَهم فى المدينة " كنا نبيت فى السلاح ، ونصبح فى السلاح "، أى أن جهوزيتهم للدفاع عن القيمة التى يؤسسونها فى الأرض كانت عالية للغاية، وكل ما أنتجته هذه الفترة وكل ما عايشه ذلك المجتمع – والقائد الأعظم بين ظهرانيهم – كانت فى حراسة السلاح ، ولو بالمعنى المعنوى ، أى الشعور بأن كل لحظة فى حياتهم نذر ووقف لمشروعهم، والذى يجلى من اتضاحه أمامهم عدوُهم المتربص بهم والذى لا يترك لهم مجالا للأمن الخارجى.
على مستوى الأفراد المؤثرين فإننى لا أكاد أجد رجلا له ذكر بين الأمم إلا إذا كان فى المقام الأول مات فى سبيل ما يدعو إليه أو على الأقل فى المقام الثانى أوذى وعذب أو سجن فى سبيل ذلك ، حتى إن الذين لم يصبهم شيئا من هذا يشك دائما فى كيفية تعاطيهم مع مخالفيهم خاصة إذا كانوا من ذوى السلطة ، فدائما السائر على الخط المستقيم لا يعدم الوقوع فى بعض الحفر التى على الخط ، أما الغير ملتزم بذلك الخط فيستطيع بكل سهولة الالتفاف والتلوى مع كل عقبة تصادفه ، مما يبطىء من سرعة وصوله للهدف أو حتى يُضله الطريق تماما.
فعندما نجد أن ثلاثة خلفاء من أصل أربعة فى عداد الشهداء ، ولو عددناهم ستة خلفاء بدخول عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن الزبير يصبحون خمسة خلفاء شهداء ، و عندما نجد أن أئمة الإسلام الأربعة لا يوجد فيهم من لم يسجن أو يمتحن نتأكد من ذلك، من أول أحمد ابن حنبل ومحنته الشهيرة، إلى الإمام أبى حنيفة الذى توفى فى سجنه من التعذيب الذى طاله وقد جاوز السبعين، إلى محنة الإمام مالك الذى ضرب نحو مئة صوت ظل أثرها على جسده حتى توفى رضى الله عنه ، إلى الإمام الشافعى الذى وضع القيد فى يده وكادت تضرب عنقه ، إلى العشرات من تلاميذهم ومن أهل العلم فى هذا الباب الواسع والكثير منهم أعجب عندما يذكر أنه مات فى محبسه ، ولا أعجب من أن نرى أعظم من أثروا فى الفكر الإسلامى القديم كابن تيمية أو الحديث كسيد قطب يتوفى الأول فى سجنه ويحكم على الأخير بالإعدام.
أما إذا خرجنا من باب العلماء والمفكرين فإن أبواب القادة والمجاهدين والدعاة والمصلحين مفتوحة على مصراعيها تسطر آلاف البشر من كل الأشكال والألوان لا فى حضارتنا فقط ، وإلى عصرنا الحالى لا يكاد الواحد منا يسمع عن رجل عظيم الشأن فيذهب لقراءة سيرته إلا ويجد له فى أيام عمره سجن أو محنة تصقل من معدنه، وتمِيزُهُ بين الرجال ، حتى أن الرجل الذى تفاخر به أقوامنا الآن على مستوى السياسة بين سجنه وتوليه رئاسة وزراء تركيا أقل من خمس سنوات.
ومع كل هذه السير وتلك المسيرات فإننى لا أدرى كيف وصلت ثقافة "الأمن" إلى وضعها الحالى فى مجتمعاتنا على مستوى الفرد المؤثر وعلى مستوى الجماعات الفاعلة ، هل بالفعل يشعر هؤلاء الأشخاص أن انعدام الأمن هو أمر غير مستغرب؟ ، أو بالأحرى لماذا يوجد حرص على وجود هذا الأمن والتضحية ببعض المكاسب الواجبة والمفروضة عليهم فى الطريق؟ ، وهل هناك درجة من انعدام هذا الأمن "التضحية" يجب أن نصل إليها أولا حتى نُعطى ما نطلبه ؟ ، لماذا لا يكون الاعتقال مثلا فى زمننا هذا هو أمر متوقع فى حياة كل فرد مؤثر؟ ، علامة مضيئة على الطريق ، وأن يكون العكس هو المستغرب، صحيح أننا لا يجب أن نتعامل معها على أنها من حق الظالم نفسه أن يعتقلنا كما يحلو له ، لكن فى الوقت نفسه ليس من حقنا أن ندفع هذا الخوف بالركون إلى خطوات من شأنها أن تبطىء عجلات الهدف الذى نصبوا لتحقيقه.
إن الطريقة الثورية فى الاحتدام بنقاط الجهل والتخلف والفساد والخواء لتُعرف من حجم الخوف الذى يلاقيه كل فرد وكل جماعة على خطوط هذه النيران ، وإن كل ابتعاد – فى وضع أمتنا الحالى – عن هذا الخط لا أخال إلا أنه يبطىء من النصر الوشيك.
دعونى أقول أن تلك الخواطر تجول فى جنانى منذ عام ، وها أنا – بهذه الليلة – أتمم عاما كاملا بعد تجربة اعتقال قصيرة ، قد أكون خسرت فى هذه نهاية هذا العام – بسبب الملف الأمنى – عملى كمراسل وكإمام وخطيب حر ، لكننى لا أستطيع أن أنكر أننى أفضل حالا بكثير، أن أجزاء كاملة من طرق التفكير ودروب العمل لدى قد تم دفعها بشكل صحيح ، والفضل أن "ألف ميم نون" أصبح لديها عندى معنى مختلف ومذاق خاص بعد تجربة مثل هذه .
حتى قد يكون الأمر أوسع من ذلك ، والنظرة أشمل من الأمن على النفس ، فحتى الأمن الاقتصادى وعدم المخاطرة برؤوس الأموال، أو الأمن على الأشخاص القريبين منى ودوام الاطمئنان المتبادل بينى وبينهم، أو الأمن العاطفى وعدم خوض تجارب ما كانت محظورة لدى سابقا، أو حتى تأخر السكن النفسى ذاته، كل هذا قد اتسق وتناسق وانتظم فى عقد جديد بعد أن كان متناثرا فى حياتى ليشكل منظومة لا تعرف الأمن ولا الأمان فى هذه الحياة ، وترتقبه فى حيوات أخرى .